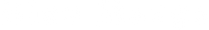لأجل إيريــس - 00
كان أبي رجل كثير النسيان.
لم يكن يتذكر مواعيده مع الجيران، ولا طلبات أمي التي كان يتعامل معها باللامبالاة. لم يكن يعلم مقدار الديون المتراكمة على حسابه في الحانة، وحتى اسم ابنته الوحيدة، لم يحفظه إلا بعد أن سمعه عشرات المرات.
كان رجلاً تافهاً وعديم المسؤولية. الجميع كانوا يلومونه ولا يشعرون تجاهه بأي شفقة، وللأمانة، كان ذلك مستحقاً.
فكل ما نسيه كان ببساطة ما أراد أن ينساه. كان يتذكر جميع المواعيد التي فيها منفعة له، لكنه ينسى تماماً تلك التي تُلزمه بشيء. لم يكن يلتفت لطلبات أمي لأنه لم يكن يريد تنفيذها. لم يسدد ديونه لأنه لم يكن يريد دفعها. ولم يهتم بي، لأنه بكل بساطة لم يكترث لأمري.
كان نموذجاً صارخاً لعدم المسؤولية، ولم يتغير حتى بعد وفاة أمي.
“إيريس، أنا أثـــــق بكِ فقط.”
لم يكن من الممكن أن يقوم رجل كهذا، يختار ما يناسبه من الذكريات، بأي عمل جاد. وبمجرد أن رحلت أمي، التي كانت تتحمل أعباء المعيشة، قرر أن يُلقي بتلك المسؤوليات على عاتقي.
كنت حينها طفلة لا تتجاوز الرابعة من العمر.
رغم سخافة الأمر، كان لديه سبب لذلك القرار، ولو بدا غير معقول.
لقد وُلدت بعينين ذهبيتين، علامة على أنني وريثة دماء وقدرات البطل العظيم أورييل، الذي يُقال إنه أنقذ العالم من كارثة كبرى. كان الـــجميع يتحدثون عن هذة الدماء المميزة، معتقدين أنها تمنحني قدرات خاصة.
لابــد أنة كان يعتقد أنها مصـــدر للمال بلا شك…
لذلك، قرر، على غير عادته، أن يبقيني معه ويربيني، لكنه كان يعرف القليل عني بسبب إهماله لي أثناء حياة أمي. لم يكن يعرف ما أحب وما أكره، ولا حتى كيف يعتني بطفل صغير. لكنني أذكر أنه كان يحرص على إطعامي.
ومع ذلك، فإن مجرد عدم تركي جائعة لم يكن يعني أنه كان أباً صالحاً.
كان علي أن أشكر نصف طبق من حساء الكرنب المائي. كنت مضطرة لتناول الطعام الذي يجلبه، حتى وإن كان يسبب لي آلاماً في المعدة. عندما يختار شيئاً من السوق، كان دائماً الأرخص، وإذا اخترت شيئاً أكثر ثمناً، كنت أُوبَّخ على إسرافي.
وكل هذا، مع العلم أن الأموال التي كان ينفقها لم تكن من كسبه، بل من التركة التي تركتها أمي.
حتى الآن، وأنا في السادسة والعشرين، لا أستطيع أن أنظر إلى تلك السنوات بإيجابية. كان لطفه هزيلاً، لكن الثمن الذي طلبه كان باهظاً. أليس هذا وصفاً ملائماً لشيء مرعب؟
لكن، لم تكن كل ذكرياتي معه سيئة. على الرغم من كل شيء، كانت هناك لحظات جميلة.
أحياناً كان يحملني على كتفيه، وكان يغني معي عندما أبدأ بالغناء، وكأنه يريدني أن أشكره على هذا اللطف البسيط. ربما كان ذلك أيضاً جزءاً من حساباته. من يدري؟ ولم أعد أرغب بمعرفة ذلك.
“لماذا أتذكر كــــل هذا الآن؟”
نهضت من سريري وقررت أن أبدأ يومي، رغم أنه كان لا يزال مبكراً. ارتديت ملابسي بسرعة، وأخذت سلة الوجبات الخفيفة التي أعددتها بالأمس، وخرجت من السكن.
عشت مع أبي ثلاث سنوات فقط.
بعدها، عندما انكشفت قدراتي، خاب أمله. فقد كنت أملك ذاكرة استثنائية، أستطيع أن أتذكر كل ما رأيته أو سمعته أو شعرت به مرة واحدة. لكنه رأى أن هذه القدرة عديمة الفائدة في كسب العيش.
إنه لمن المضحك الآن أنني أستطيع أن أرى كيف كان يمكنه الاستفادة من تلك القدرة، حتى في لعب القمار مثلاً. لكن، أبي لم يكن ذكياً كفاية لذلك.
قرر أنه لم يعد بإمكانه “الاستثمار” فيّ أكثر. وهكذا، اتخذ قراره، بترك ابنته الوحيدة.
“إيريس، سيهتم هؤلاء الناس بك لفتــــرة قصيرة. سأعود بمجرد أن أجمع المال.”
كنت أملك ذاكرة قوية للغاية. أتذكر كل شيء عن ذلك اليوم. كيف كذب أبي وهو يلتقط شفتيه بعصبية، وكيف اختار الطريق الأكثر صعوبة للوصول إلى دار الأيتام، بدلاً من الأقصر.
“متى ســــتعودين؟”
“عندما أجمع الكثير من المال؟ لا تقلقي، لن يستغـــرق الأمر وقتاً طويلاً. سأعود قريباً.”
لكنني كنت أعلم أن ذلك لن يحدث. لأنه رجل ينــــسى كل ما لا يريد أن يتذكره. كان واضحاً أنه لن يعود، وسيترك كل شيء خلفه كما فعل دائماً.
رغم كل ذلك، لم أستطع التوقف عن البكاء حينها. ربما بسبب أملي الطــــفولي أنه قد يعود ليأخذني يوماً ما. لكنه لم يفعل.
مرت السنوات، وبلغت سن الرشد. خرجت من دار الأيتام ووجدت عملاً بفضل وضعي كواحدة من ورثة أورييل. أصبحت أمينة مكتبة في مكتبة مونتريشت الوطنية.
هذا العمل، رغم بساطته، كان نعمة كبيرة بالنسبة لي. فهو يوفر لي الاستقرار الذي احتجته لبدء حياتي من جديد. الآن، وبعد ثماني سنوات، ما زلت أعمل هناك.
ولكن، مع امتلاء الأرفف في المكتبات الثلاثة عشر الأخرى بالكامل، أصبح من الضروري توفير مساحة لتخزين الكتب الزائدة. لذلك، تم تحويل هذا المكان إلى المكتبة الرابعة عشرة واستُخدم لهذا الغرض.
كان ذلك خيارًا لا مفر منه، إذ لا يمكن التخلص من الكتب السليمة ببساطة، لكنه لم يكن الخيار الأمثل.
رغم أنه أصبح مكانًا مقبولاً للعرض، إلا أن المكتبة الرابعة عشرة كانت تتكون في الغالب من كتب فائضة وغير ضرورية من المكتبات الأخرى، مما جعل محتوياتها ضعيفة إلى حدّ يثير الشفقة.
إضافةً إلى ذلك، وباعتبار أن المبنى كان في الأصل مستودعًا، كان موقعه معزولًا وبعيدًا عن الأنظار. بعبارة أخرى، كان الوصول إليه في غاية الصعوبة.
في البداية، اجتذب ظهور المكتبة الجديدة الزوار الذين رأوا فيها شيئًا جديدًا وغريبًا، لكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى بدأ الناس يتجاهلون المكتبة بسبب نقائصها العديدة.
ومع قلة الزوار، توقفت الموارد والدعم من الجهات المعنية، مما جعل تحسين الأوضاع مستحيلًا. أدى ذلك إلى حلقة مفرغة: قلة الدعم أدت إلى قلة التحسينات، مما أدى بدوره إلى قلة الزوار، وهكذا.
وبسبب هذه الظروف، بات عدد زوار المكتبة الرابعة عشرة لا يتعدى بضعة أفراد في السنة. والأدهى أن هؤلاء القلائل غالبًا ما يكونون مجرد ضائعين بين الممرات الواسعة للمكتبة العامة، وليسوا زوارًا حقيقيين.
في ظل هذا الواقع، كان من الطبيعي أن تكون الموارد البشرية شحيحة للغاية. بل إن تلك الظروف هي التي أطلقت على المكتبة لقب “منفى أمناء المكتبة”.
كانت تلك التسمية مناسبة جدًا، خاصة أن الإدارة العليا، التي لا تفقه شيئًا في العمل الميداني، قررت بسبب غياب الزوار سحب جميع الموظفين المتبقين، مثل عمال النظافة والبستانيين، وترك أمناء المكتبة وحدهم لتحمل العبء.
وهكذا، بات على أمين المكتبة أن يتحمل مسؤولية العناية بالمكتبة وحده، ما جعله يبدو كمنفي في مكان معزول.
ولكن، كيف أشرح هذا المشهد الآن؟ الوضع يبدو غريبًا جدًا لدرجة يصعب وصفها باختصار. باختصار، عندما وصلت إلى المكتبة هذا الصباح، وجدت رجلاً يرتدي معطفًا أسود طويلًا يقف بتأنٍ ويسقي النباتات في الحديقة. قد تبدو هذه الجملة غريبة للغاية، لكنها الحقيقة.
كان الرجل قد رفع أكمام معطفه السميكة بعناية، وانحنى برفق كي لا يُلحق الضرر بالنباتات وهو يصب الماء من مرشة صغيرة.
الأمر المثير للدهشة أنني أنا المسؤولة عن ري الحديقة، ومع ذلك، أراه هنا لأول مرة في حياتي. والأغرب من ذلك أن المعطف الأسود الذي يرتديه هو رمز من رموز الجيش. فما الذي يفعله جندي هنا؟
حتى لو افترضنا أنه زائر عادي، فمن المستحيل أن يكون قد وجد تلك المرشة الصغيرة وحده في المخزن وأحضرها ليسقي النباتات!
استغرقت لحظات لإدراك أن التفكير في الأمر وحدي لن يجدي نفعًا. في النهاية، أنا المسؤولة الوحيدة عن المكتبة، ولا يوجد أحد سواي لأسأله.
اقتربت منه وسألته
“عذرًا، هل لي أن أعرف سبب وجودك هنا؟ لم أتلقَّ أي إشعار بزيارة من الجيش.”
حينها فقط لاحظ وجودي. استدار ببطء لينظر إليّ، وهنا بدأت الأسئلة تتزاحم في رأسي.
عندما التقت أعيننا، شعرت بشيء غريب للغاية. كان هناك العديد من الأسئلة التي أردت طرحها كجزء من واجبي كأمينة المكتبة، ولكن حينما رأيت ملامحه، توقفت الكلمات عند حلقي.
كان رجلاً طويل القامة، بشعر أسود داكن، وحاجبين كــثيفين، وعينين حادتين، وأنف شامخ، وذقن صلبة ناعمة الخطوط.
كان من المستحيل ألا تلاحظ جمال ملامحه، لكن هذا لم يكن السبب الذي أفقدني الكلمات.
ما جعلني عاجزة عن الحديث هو التعبير الذي ارتسم على وجهه. كان وجهه جامدًا في البداية، ثم بدأ يتغير تدريجيًا، ليصبح مشوشًا بين البكاء والضحك.
ما الذي يجري اليوم؟ لماذا يبدو كل شيء محيرًا؟
ربما كنت سأصرف نظري عن ذلك الوجه الذي لم أره قط من قبل، لكن شيئًا ما جعلني غير قادرة على ذلك. كان هناك شعور غريب، لأن ذلك الرجل، بكل بساطة، بدا سعيدًا للغاية لرؤيتي.